|
||||||
|
(361)
خلاق الاجتماعية ، أو الفهم العام العادي الذي هو إساس التكاليف العامة الدينية ،
فللعقل أحكام ، وللحب إحكام ، وسيجئ توضيح هذا المعنى في بعض الابحاث الآتية إنشاء
الله تعالى.
قوله تعالى : « أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون » الآية. التدبر في الآية يعطي أن الصلوة غير الرحمة بوجه ، ويشهد به جمع الصلوة وإفراد الرحمة وقد قال تعالى : « هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما » الاحزاب ـ 43 ، والآية تفيد كون قوله : « وكان بالمؤمنين رحيما » ، في موقع العلة لقوله : هو الذي يصلي عليكم ، والمعنى انه انما يصلي عليكم ، وكان من اللازم المترقب ذلك ، لان عادته جرت على الرحمة بالمؤمنين ، وأنتم مؤمنون فكان من شأنكم أن يصلي عليكم حتى يرحمكم ، فنسبة الصلوة إلى الرحمة نسبة المقدمة إلى ذيها وكالنسبة التي بين الالتفات والنظر ، والتى بين الالقاء في النار والاحراق مثلا ، وهذا يناسب ما قيل في معنى الصلوة : أنها الانعطاف والميل ، فالصلوة من الله سبحانه إنعطاف إلى العبد بالرحمة ومن الملائكة إنعطاف إلى الانسان بالتوسط في إيصال الرحمة ، ومن المؤمنين رجوع ودعاء بالعبودية وهذا لا ينافي كون الصلوة بنفسها رحمة ومن مصاديقها ، فإن الرحمة في القرآن على ما يعطيه التدبرفي مواردها هي العطية المطلقة الالهية ، والموهبة العامة الربانية ، كما قال تعالى : « ورحمتي وسعت كل شئ » الاعراف ـ 156 ، وقال تعالى : « وربك الغني ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين » الانعام ـ 133 ، فالاذهاب لغناه والاستخلاف والانشاء لرحمتة ، وهما جميعا يستندان إلى رحمته كما يستندان إلى غناه فكل خلق وأمر رحمة ، كما أن كل خلق وأمر عطية تحتاج إلى غني ، قال تعالى : « وما كان عطاء ربك محظورا » الاسراء ـ 20 ، وإن عطيته الصلوة فهي أيضا من الرحمة غير أنها رحمة خاصة ، ومن هنا يمكن أن يوجه جمع الصلوة وإفراد الرحمة في الآية. قوله تعالى : وأولئك هم المهتدون كأنه بمنزلة النتيجة لقوله : أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، ولذلك جدد اهتدائهم جملة ثانية مفصولة عن الاولى ، ولم يقل : صلوات من ربهم ورحمة وهداية ، ولم يقل : واولئك هم المهديون بل ذكر قبولهم للهداية بالتعبير بلفظ الاهتداء الذي هو فرع مترتب على الهداية ، فقد تبين (362)
أن
الرحمة هدايتهم إليه تعالى ، والصلوات كالمقدمات لهذه الهداية واهتدائهم نتيجة هذه
الهداية ، فكل من الصلوة والرحمة والاهتداء غير الآخر وإن كان الجميع رحمة بنظر آخر.
فمثل هؤلاء المؤمنين في ما يخبره الله من كرامته عليهم مثل صديقك تلقاه وهو يريد دارك ، ويسئل عنها يريد النزول بك فتلقاه بالبشر والكرامة ، فتورده مستقيم الطريق وأنت معه تسيره ، ولا تدعه يضل في مسيره حتى تورده نزله من دارك وتعاهده في الطريق بمأكله ومشربه ، وركوبه وسيره ، وحفظه من كل مكروه يصيبه فجميع هذه الامور إكرام واحد لانك إنما تريد إكرامه ، وكل تعاهد تعاهد وإكرام خاص والهداية غير الاكرام ، وغير التعاهد ، وهو مع ذلك إكرام فكل منها تعاهد وكل منها هداية وكل منها إكرام خاص ، والجميع إكرام ، فالاكرام الواحد العام بمنزلة الرحمة والتعاهدات في كل حين بمنزلة الصلوات ، والنزول في الدار بمنزلة الاهتداء. والاتيان بالجملة الاسمية في قوله : واولئك هم المهتدون ، والابتداء باسم الاشاره الدال على البعيد ، وضمير الفصل ثانيا وتعريف الخبر بلام الموصول في قوله : المهتدون كل ذلك لتعظيم أمرهم وتفخيمه ـ والله أعلم ـ. ( بحث روائي )
في البرزخ وحيوة الروح بعد الموت
في تفسير القمي عن سويد بن غفلة عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة مثل له ماله
وولده وعمله ، فيلتفت إلى ماله فيقول : والله إني كنت عليك لحريصا شحيحا ، فما لي
عندك ؟ فيقول : خذ مني كفنك ، ثم يلتفت إلى ولده فيقول : والله إني كنت لكم لمحبا ، وإني
كنت عليكم لحاميا ، فما ذا لي عندكم ؟ فيقولون : نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها ، ثم
يلتفت إلى عمله فيقول : والله إني كنت فيك لزاهدا ، وإنك كنت علي لثقيلا ، فما ذا
عندك ؟ فيقول : أنا قرينك في قبرك ، ويوم حشرك ، حتى أعرض أنا وأنت على ربك ، فإن
(363)
كان
لله وليا أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا ، وأزينهم رياشا ، فيقول : بشر بروح من
الله وريحان وجنة نعيم ، قد قدمت خير مقدم ، فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ،
ارتحل من الدنيا إلى الجنة ، وإنه ليعرف غاسلة ، ويناشد حامله أن يعجله.
فإذا دخل قبره أتاه ملكان ، وهما فتانا القبر ، يحبران أشعارهما ، ويحبران الارض
بأنيابهما ، وأصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، فيقولان له : من ربك ،
ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فيقول : الله ربي ، ومحمد نبيي ، والاسلام ديني ، فيقولان : ثبتك
الله فيما تحب وترضى ، وهو قول الله :« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة
الدنيا » الآية ، فيفسحان له في قبره مد بصره ، ويفتحان له بابا إلى الجنة ، ويقولان : نم
قرير العين نوم الشاب الناعم ، وهو قوله : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشا ، وأنتنه ريحا ، فيقول له أبشر بنزل من حميم ، وتصميه جحيم ، وإنه ليعرف غاسله ، ويناشد حامله أن يحبسه ، فإذا أدخل قبره أتيا ممتحنا القبر ، فألفيا عنه أكفانه ثم قالا له ، من ربك ؟ ومن نبيك ؟ وما دينك ؟ فيقول : لا أدري فيقولان له : ما دريت ولا هديت ، فيضربانه بمرزبه ضربة ، ما خلق الله دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلان ، ثم يفتحان له بابا إلى النار ، ثم يقولان له : نم بشر حال ، فيبوء من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج ، حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره ولحمه ، ويسلط الله عليه حيات الارض وعقاربها وهوامها تنهشه حتى يبعثه الله من قبره ، وأنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر. وفي منتخب البصائرعن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يسئل في القبر إلا من محض الايمان محضا ، أو محض الكفر محضا فقلت له : فسائر الناس ؟ فقال : يلهى عنهم. وفي أمالي الشيخ عن ابن ظبيان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم ؟ قلت : يقولون في حواصل طيور خضر ؟ فقال : سبحان الله ، المؤمن أكرم على الله من ذلك ! إذا كان ذلك أتاه رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ( عليه السلام ) ، ومعهم ملائكة الله عزوجل المقربون ، فان (364)
أنطق الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد ، وللنبي بالنبوة ، والولاية لاهل البيت ، شهد
على ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم السلام ) والملائكة المقربون معهم وإن اعتقل لسانه خص الله نبيه بعلم ما في قلبمن ذلك ، فشهد
به ، وشهد على شهادة النبي : علي وفاطمة والحسن والحسين ـ على جماعتهم من الله أفضل
السلام ـ ومن حضر معهم من الملائكة فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة ،
في صورة كصورته ، فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي
كانت في الدنيا.
وفي المحاسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر الارواح ، أرواح المؤمنين فقال يلتقون ، قلت : يلتقون ؟ قال : نعم يتسائلون و يتعارفون حتى إذا رأيته قلت : فلان. وفي الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب ، ويستر عنه ما يكره ، وإن الكافر ليزور أهله ، فيرى ما يكره ، ويستر عنه ما يحب ، قال : منهم من يزور كل جمعه ، ومنهم من يزور على قدر عمله. وفي الكافي عن الاصادق ( عليه السلام ) : أن الارواح في صفة الاجساد في شجر من الجنة ، تعارف وتسائل ، فإذا قدمت الروح على الارواح تقول : دعوها ، فإنها قد أقبلت من هول عظيم ثم يسئلونها ما فعل فلان ، وما فعل فلان ، فإن قالت لهم : تركته حيا ارتجوه ، وإن قالت لهم : قد هلك ، قالوا : قد هوى هوى اقول : والروايات في باب البرزخ كثيرة ، وإنما نقلنا ما فيه جوامع معنى البرزخ ، وفي المعاني المنقولة روايات مستفيضة كثيرة ، وفيها دلالة على نشأة مجردة عن المادة ( بحث فلسفي )
هل النفس مجردة عن الماده ؟ ( ونعني بالنفس ما يحكى عنه كل واحد منا بقوله ،
أنا ، وبتجردها عدم كونها أمرا ماديا ذا انقسام وزمان ومكان.
(365)
إنا
لا نشك في أنا نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه : بأنا ، ولا نشك أن كل إنسان هو
مثلنا في هذه المشاهدة التي لا نغفل عنه حينا من أحيان حيوتنا وشعورنا ، وليس هو
شيئا من أعضائنا ، وأجزاء بدننا التي نشعر بها بالحس أو بنحو من الاستدلال كأعضائنا
الظاهرة المحسوسة بالحواس الظاهرة من البصر واللمس ونحو ذلك ، وأعضائنا الباطنة التي
عرفناها بالحس والتجربة ، فإنا ربما نغفل عن كل واحد منها وعن كل مجموع منها حتى عن
مجموعها التام الذي نسميه بالبدن ، ولا نغفل قط عن المشهود الذي نعبر عنه : بأنا ، فهو
غير البدن وغير أجزائه.
وأيضا لو كان هو البدن أو شيئا من أعضائه أو أجزائه : أو خاصة من الخواص الموجودة فيها ـ وهى جميعا مادية ، ومن حكم المادة التغير التدريجي وقبول الانقسام والتجزي ـ لكان ماديا متغيرا وقابلا للانقسام وليس كذلك فإن كل أحد أذا رجع إلى هذه المشاهدة النفسانية اللازمة لنفسه ، وذكر ما كان يجده من هذه المشاهدة منذ أول شعوره بنفسه وجده معنى مشهودا واحدا باقيا على حاله من غير أدنى تعدد وتغير ، كما يجد بدنه وأجزاء بدنه ، والخواص الموجودة معها متغيرة متبدلة من كل جهة ، في مادتها وشكلها ، وسائر أحوالها وصورها ، وكذا وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزي ، كما يجد البدن ، وأجزائه وخواصه ـ وكل مادة وأمر مادي كذلك ـ فليست النفس هي البدن ، ولا جزءا من أجزائه ، ولا خاصة من خواصه ، سواء أدركناه بشئ من الحواس أو بنحو من الاستدلال ، أو لم ندرك ، فإنها جميعا مادية كيفما فرضت ، ومن حكم المادة التغير ، وقبول الانقسام ، والمفروض أن ليس في مشهودنا المسمى بالنفس شئ من هذه الاحكام فليست النفس بمادية بوجه. وأيضا هذا الذي نشاهده نشاهده أمرا واحدا بسيطا ليس فيه كثرة من الاجزاء ولا خليط من خارج بل هو واحد صرف فكل إنسان يشاهد ذلك من نفسه ويرى أنه هو وليس بغيره فهذا المشهود أمر مستقل في نفسه ، لا ينطبق عليه حد المادة ولا يوجد فيه شئ من أحكامها اللازمة ، فهو جوهر مجرد عن المادة ، متعلق بالبدن نحو تعلق يوجب اتحادا ما له بالبدن وهو التعلق التدبيري وهو المطلوب. وقد أنكر تجرد النفس جميع الماديين ، وجمع من الالهيين من المتكلمين ، والظاهريين (366)
من
المحدثين ، واستدلوا على ذلك ، وردوا ما ذكر من البرهان بما لا يخلو عن تكلف من غير
طائل.
قال الماديون : إن الابحاث العلمية على تقدمها وبلوغها اليوم إلى غاية الدقة في فحصها وتجسسها لم تجد خاصة من الخواص البدنية إلا وجدت علتها الماديه ، ولم تجد أثرا روحيا لا يقبل الانطباق على قوانين المادة حتى تحكم بسببها بوجود روح مجردة. قالوا : وسلسلة الاعصاب تؤدي الادراكات إلى العضو المركزي وهو الجزء الدماغي على التوالي وفي نهاية السرعة ، ففيه مجموعة متحدة ذات وضع واحد لا يتميز أجزائها ولا يدرك بطلان بعضها ، وقيام الآخر مقامه ، وهذا الواحد المتحصل هو نفسنا التي نشاهدها ، ونحكي عنها بأنا ، فالذي نرى أنه غير جميع أعضائنا صحيح إلا أنه لا يثبت أنه غير البدن وغير خواصه ، بل هو مجموعة متحدة من جهة التوالي والتوارد لا نغفل عنه ، فإن لازم الغفلة عنه على ما تبين بطلان الاعصاب ووقوفها عن أفعالها وهو الموت ، والذي نرى أنه ثابت ، صحيح لكنه لا من جهة ثباته وعدم تغيره في نفسه بل الامر مشتبه على المشاهدة من جهة توالي الواردات الادراكية وسرعة ورودها ، كالحوض الذي يرد عليه الماء من جانب ويخرج من جانب بما يساويه وهو مملوء دائما ، فما فيه من الماء يجده الحس واحدا ثابتا ، وهو بحسب الواقع لا واحد ولا ثابت ، وكذا يجد عكس الانسان أو الشجر أو غيرهما فيه واحدا ثابتا وليس واحدا ثابتا بل هو كثير متغير تدريجا بالجريان التدريجي الذي لاجزاء الماء فيه ، وعلى هذا النحو وجود الثبات والوحدة والشخصية التي نرى في النفس. قالوا : فالنفس التي يقام البرهان على تجردها من طريق المشاهدة الباطنية هي في الحقيقة مجموعة من خواص طبيعية ، وهي الادراكات العصبية التي هي نتائج حاصلة من التأثير والتأثر المتقابلين بين جزء المادة الخارجية ، وجزء المركب العصبي ، ووحدتها وحدة اجتماعية لا وحدة واقعية حقيقية. أقول : أما قولهم : إن الابحاث العلمية المبتنية على الحس والتجربة لم تظفر في سيرها الدقيق بالروح ، ولا وجدت حكما من الاحكام غير قابل التعليل إلا بها فهو كلام (367)
حق
لا ريب فيه لكنه لا ينتج انتفاء النفس المجردة التي اقيم البرهان على وجودها ، فإن
العلوم الطبيعية الباحثة عن أحكام الطبيعة وخواص المادة إنما تقدر على تحصيل خواص
موضوعها الذي هو المادة ، وإثبات ما هو من سنخها ، وكذا الخواص والادوات المادية التي
نستعملها لتتميم التجارب المادي إنما لها أن تحكم في الامور المادية ، وأما ما وراء
المادة والطبيعة ، فليس لها أن تحكم فيها نفيا ولا إثباتا ، وغاية ما يشعر البحث
المادي به هو عدم الوجدان ، وعدم الوجدان غير عدم الوجود ، وليس من شأنه كما عرفت أن
يجد ما بين المادة التي هي موضوعها ، ولا بين أحكام المادة وخواصها التي هي نتائج
بحثها أمر أمجردا خارجا عن سنخ المادة وحكم الطبيعة.
والذي جرأهم على هذا النفي زعمهم أن المثبتين لهذه النفس المجردة إنما أثبتوها لعثورهم إلى أحكام حيوية من وظائف الاعضاء ولم يقدروا على تعليلها العلمي ، فأثبتوا النفس المجردة لتكون موضوعا مبدئا لهذه الافاعيل ، فلما حصل العلم اليوم على عللها الطبيعية لم يبق وجه للقول بها ، نظير هذا الزعم ما زعموه في باب إثبات الصانع. وهو اشتباه فاسد فإن المثبتين لوجود هذه النفس لم يثبتوها لذلك ولم يسندوا بعض الافاعيل البدنية إلى البدن فيما علله ظاهرة ، وبعضها إلى النفس فيما علله مجهولة ، بل أسندوا الجميع إلى العلل البدنية بلا واسطة وإلى النفس بواسطتها ، وإنما اسندوا إلى النفس ما لا يمكن إسناده إلى البدن ألبتة وهو علم الانسان بنفسه ومشاهدته ذاته كما مر. وأما قولهم : إن الانية المشهودة للانسان على صفة الوحدة هي عدة من الادراكات العصبية الواردة على المركز على التوالي وفي نهاية السرعة ـ ولها وحدة اجتماعية ـ فكلام لا محصل له ولا ينطبق عليه الشهود النفساني البتة ، وكأنهم ذهلوا عن شهودهم النفساني فعدلوا عنه إلى ورود المشهودات الحسية إلى الدماغ واشتغلوا بالبحث عما يلزم ذلك من الآثار التالية وليت شعري إذا فرض أن هناك امورا كثيرة بحسب الواقع لا وحدة لها ألبتة ، وهذه الامور الكثيرة التي هي الادراكات امور مادية ليس ورائها شئ آخر إلا نفسها ، وإن الامر المشهود الذي هو النفس الواحدة هو عين هذه (368)
الادراكات الكثيرة ، فمن أين حصل هذا الواحد الذي لا نشاهد غيره ؟ ومن أين حصلت هذه
الوحدة المشهودة فيها عيانا ؟ والذي ذكروه من وحدتها الاجتماعية كلام أشبه بالهزل
منه بالجد فإن الواحد الاجتماعي هو كثير في الواقع من غير وحدة وإنما وحدتها في
الحس أو الخيال كالدار الواحدة والخط الواحد مثلا ، لا في نفسه ، والمفروض في محل
كلامنا أن الادراكات والشعورات الكثيرة في نفسها هي شعور واحد عند نفسها فلازم
قولهم إن هذه الادراكات في نفسها كثيرة لا ترجع إلى وحدة أصلا ، وهي بعينها شعور
واحد نفساني واقعا ، وليس هناك أمر آخر له هذه الادراكات الكثيرة فيدركها على نعت
الوحدة كما يدرك الحاسة أو الخيال المحسوسات أو المتخيلات الكثيرة المجتمعة على وصف
الوحدة الاجتماعية ، فإن المفروض أن مجموع الادراكات الكثيرة في نفسها نفس الادراك
النفساني الواحد في نفسه ، ولو قيل : إن المدرك هيهنا الجزء الدماغي يدرك الادراكات
الكثيرة على نعت الوحدة كان الاشكال بحاله ، فإن المفروض ان إدراك الجزء الدماغي نفس
هذه الدراكات الكثيرة المتعاقبة بعينها ، لا أن للجزء الدماغي قوة إدراك تتعلق بهذه
الادراكات كتعلق القوى الحسية بمعلوماتها الخارجية وانتزاعها منها صورا حسية ، فافهم
ذلك.
والكلام في كيفية حصول الثبات والبساطة في هذا المشهود الذي هو متغير متجز في نفسه كالكلام في حصول وحدته. مع أن هذا الفرض أيضا ـ أعني أن يكون الادراكات الكثيرة المتوالية المتعاقبة مشعورة بشعور دماغي على نعت الوحدة ـ نفسه فرض غير صحيح ، فما شأن الدماغ والقوة التي فيه ، والشعور الذي لها ، والمعلوم الذي عندها ، وهي جميعا امور مادية ، ومن شأن المادة والمادي الكثرة ، والتغير ، وقبول الانقسام ، وليس في هذه الصورة العلمية شئ من هذه الاوصاف والنعوت ، وليس غير المادة والمادي هناك شئ. وقولهم : أن الامر يشتبه على الحس أو القوة المدركة ، فيدرك الكثير المتجزي المتغير واحدا بسيطا ثابتا غلط واضح ، فإن الغلط والاشتباه من الامور النسبية التي تحصل بالمقايسة والنسبة ، لا من الامور النفسية ، مثال ذلك أنا نشاهد الاجرام العظيمة السماوية صغيرة كالنقاط البيض ، ونغلط في مشاهدتنا هذه ، على ما تبينه البراهين (369)
العلمية ، وكثير من مشاهدات حواسنا إلا أن هذه الاغلاط إنما تحصل وتوجد إذا قايسنا
ما عند الحس مما في الخارج من واقع هذه المشهودات ، وأما ما عند الحس في نفسه فهو
أمر واقعي كنقطة بيضاء لا معنى لكونه غلطا ألبتة.
والامر فيما نحن فيه من هذا القبيل فإن حواسنا وقوانا المدركة إذا وجدت الامور الكثيرة المتغيرة المتجزية على صفة الوحدة والثبات والبساطة كانت القوى المدركة غالطة في إدراكها مشتبهة في معلومها بالقياس إلى المعلوم الذي في الخارج وأما هذه الصورة العلمية الموجودة عند القوة فهي واحدة ثابتة بسيطة في نفسها ألبتة ، ولا يمكن أن يقال للامر الذي هذا شأنه : إنه مادي لفقده أوصاف المادة العامة. فقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الحجة التي أوردها الماديون من طريق الحس والتجربة إنما ينتج عدم الوجدان ، وقد وقعوا في المغالطة بأخذ عدم الوجود ( وهو مدعاهم ) مكان عدم الوجدان ، وما صوروه لتقرير الشهود النفساني المثبت لوجود أمر واحد بسيط ثابت تصوير فاسد لا يوافق ، لا الاصول المادية المسلمة بالحس والتجربة ، ولا واقع الامر الذي هو عليه في نفسه. وأما ما افترضه الباحثون في علم النفس الجديد في أمر النفس وهو أنه الحالة المتحدة الحاصلة من تفاعل الحالات الروحية ، من الادراك والارادة والرضا والحب وغيرها المنتجة لحالة متحدة مؤلفة فلا كلام لنا فيه ، فإن لكل باحث أن يفترض موضوعا ويضعه موضوعا لبحثه ، وإنما الكلام فيه من حيث وجوده وعدمه في الخارج والواقع مع قطع النظر عن فرض الفارض وعدمه ، وهو البحث الفلسفي كما هو ظاهر على الخبير بجهات البحث. وقال قوم آخرون من نفاة تجرد النفس من المليين : إن الذي يتحصل من الامور المربوطة بحيوة الانسان كالتشريح والفيزيولوجي أن هذه الخواص الروحية الحيوية تستند إلى جراثيم الحيوة والسلولات التي هي الاصول في حيوة الانسان وسائر الحيوان وتتعلق بها ، فالروح خاصة وأثر مخصوص فيها لكل واحد منها أرواح متعددة فالذي (370)
يسميه الانسان روحا لنفسه ويحكي عنه بأنا مجموعة متكونة من أرواح غير محصورة على
نعت الاتحاد والاجتماع ، ومن المعلوم أن هذه الكيفيات الحيوية والخواص الروحية تبطل
بموت الجراثيم والسلولات وتفسد بفسادها فلا معنى للروح الواحدة المجردة الباقية بعد
فناء التركيب البدني غاية الامر أن الاصول المادية المكتشفة بالبحث العلمي لما لم
تف بكشف رموز الحيوة كان لنا أن نقول : أن العلل الطبيعية لا تفي بإيجاد الروح فهي
معلولة لموجود آخر وراء الطبيعة ، وأما الاستدلال على تجرد النفس من جهة العقل محضا
فشئ لا يقبله ولا يصغي إليه العلوم اليوم لعدم اعتمادها على غير الحس والتجربة ،
هذا.
اقول : وأنت خبير بأن جميع ما أوردناه على حجة الماديين وارد على هذه الحجة المختلقة من غير فرق ونزيدها أنها مخدوشة اولا : بأن عدم وفاء الاصول العلمية المكتشفة إلى اليوم ببيان حقيقة الروح والحيوة لا ينتج عدم وفائها أبدا ولا عدم انتهاء هذه الخواص إلى العلل المادية في نفس الامر على جهل منا ، فهل هذا إمغالطة وضع فيها العلم بالعدم مكان عدم العلم ؟ وثانيا : بأن استناد بعض حوادث العالم ـ وهي الحوادث المادية ـ إلى المادة ، وبعضها الاخر وهي الحوادث الحيوية إلى أمر وراء المادة ـ وهو الصانع ـ قول بأصلين في الايجاد ، ولا يرتضيه المادي ولا الالهي ، وجميع أدلة التوحيد يبطله. وهنا إشكالات أخر أوردوها على تجرد النفس مذكورة في الكتب الفلسفية والكلامية غير أن جميعها ناشئة عن عدم التأمل والامعان فيما مر من البرهان ، وعدم التثبت في تعقل الغرض منه ، ولذلك أضربنا عن إيرادها ، والكلام عليها ، فمن أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى مظانها ، والله الهادي ( بحث اخلاقي )
علم الاخلاق ( وهو الفن الباحث عن
الملكات الانسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والانسانية ، وتميز الفضائل
منها من الرذائل ليستكمل الانسان التحلي
(371)
والاتصاف بها سعادته العلمية ، فيصدر عنه من الافعال ما يجلب الحمد العام والثناء
الجميل من المجتمع الانساني ) يظفر ببحثه أن الاخلاق الانسانية تنتهي إلى قوى عامه
ثلاثة فيه هي الباعثة للنفس على اتخاذ العلوم العملية التي تستند وتنتهي إليها
افعال النوع وتهيئتها وتعبيتها عنده ، وهي القوى الثلاث : الشهوية والغضبية والنطقية
الفكرية ، فإن جميع الاعمال والافعال الصادرة عن الانسان إمامن قبيل الافعال
المنسوبة إلى جلب المنفعة كالاكل والشرب واللبس وغيرها ، وإما من الافعال المنسوبة
إلى دفع المضرة كدفاع الانسان عن نفسه وعرضه وماله ونحو ذلك ، وهذه الافعال هي
الصادرة عن المبدا الغضبي كما أن القسم السابق عليها صادر عن المبدا الشهوي ، وإما
من الاعمال المنسوبة إلى التصور والتصديق الفكري ، كتأليف القياس وإقامة الحجة وغير
ذلك وهذه الافعال صادرة عن القوة النطقية الفكرية ، ولما كانت ذات الانسان كالمؤلفة ،
المركبة من هذه القوى الثلاث التي باتحادها وحصول الوحدة التركيبية منها يصدر أفعال
خاصة نوعية ، ويبلغ الانسان سعادتة التي من أجلها جعل هذا التركيب ، فمن الواجب لهذا
النوع إن لا يدع قوة من هذه القوى الثلاث تسلك مسلك الافراط أو التفريط ، وتميل عن
حاق الوسط إلى طرفي الزيادة والنقيصة ، فإن في ذلك خروج جزء المركب عن المقدار
المأخوذ منه في جعل أصل التركيب وفي ذلك خروج المركب عن كونه ذاك المركب ولازمه
بطلان غاية التركيب التي هي سعادة النوع.
وحد الاعتدال في القوة الشهوية ـ وهي استعمالها على ما ينبغي كما وكيفا ـ يسمي عفة ، والجانبان في الافراط والتفريط الشره والخمود ، وحد الاعتدال في القوة الغضبية هي الشجاعة والجانبان التهور والجبن ، وحد الاعتدال في القوة الفكرية تسمي حكمة والجانبان الجربزة والبلادة ، وتحصل في النفس من اجتماع هذه الملكات ملكة رابعة هي كالمزاج من الممتزج ، وهي التي تسمى عدالة ، وهي إعطاء كل ذي حق من القوي حقة ، ووضعه في موضعه الذي ينبغي له ، والجانبان فيها الظلم والانظلام. فهذه أصول الاخلاق الفاضلة أعني : العفة والشجاعة والحكمة والعدالة ، ولكل منها فروغ ناشئة منها راجعة بحسب التحليل إليها ، نسبتها إلى الاصول المذكورة كنسبة النوع إلى الجنس ، كالجود والسخاء ، والقناعة والشكر ، والصبر والشهامة ، (372)
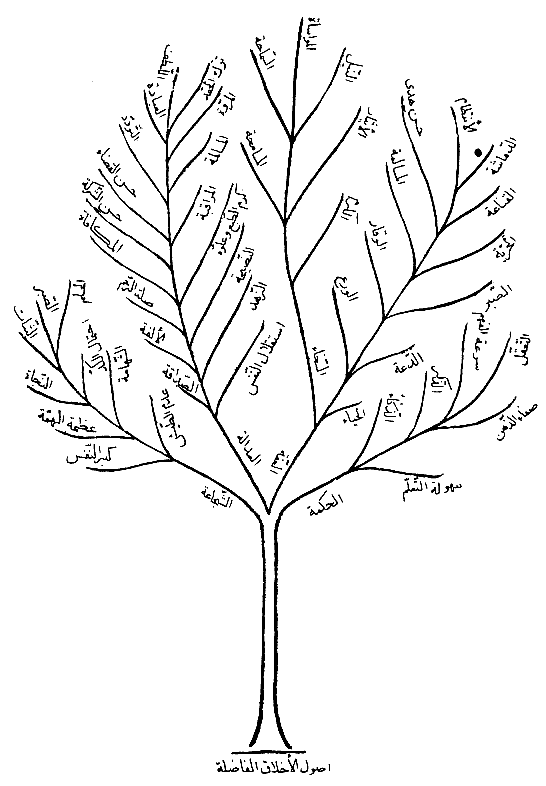 (373)
والجرئة والحياء ، والغيرة والنصيحة ، والكرامة والتواضع ، وغيرها ، هي فروع الاخلاق
الفاضلة المضبوطة في كتب الاخلاق ( وهاك شجرة تبين أصوللا وتفرع فروعها ) وعلم
الاخلاق يبين حد كل واحد منها ويميزها من جانبيها في الافراط والتفريط ، ثم يبين
أنها حسنة جميلة ثم يشير إلى كيفية اتخاذها ملكة في النفس من طريقي العلم والعمل
أعنى الاذعان بنأها حسنة جميلة ، وتكرار العمل بها حتى تصير هيئة راسخة في النفس.
مثاله أن يقال إن الجبن إنما يحصل من تمكن الخوف من النفس ، والخوف إنما يكون من أمر ممكن الوقوع وعدم الوقوع ، والمساوي الطرفين يقبح ترجيح أحد طرفيه على الآخر من غير مرجح والانسان العاقل لا ينبغي له ذلك فلا ينبغي للانسان أن يخاف. فإذا لقن الانسان نفسه هذا القول ثم كرر الاقدام والورود في المخاوف والمهاول زالت عنه رذيلة الخوف ، وهكذا الامر في غيره من الرذائل والفضائل. فهذا ما يقتضيه المسلك الاول على ما تقدم في البيان وخلاصته إصلاح النفس وتعديل ملكاتها لغرض الصفة المحمودة والثناء الجميل. ونظيره ما يقتضيه المسلك الثاني ، وهو مسلك الانبياء وأرباب الشرائع ، وإنما التفاوت من حيث الغرض والغاية ، فإن غاية الاستكمال الخلقي في المسلك الاول الفضيلة المحمودة عند الناس والثناء الجميل منهم ، وغايته في المسلك الثاني السعادة الحقيقية للانسان وهو استكمال الايمان بالله وآياته ، والخبر الاخروي وهي سعادة وكمال في الواقع لا عند الناس فقط ، ومع ذلك فالمسلكان يشتركان في أن الغاية القصوى والغرض فيها الفضيلة الانسانية من حيث العمل. وأما المسلك الثالث المتقدم بيانه فيفارق الاولين بأن الغرض فيه ابتغاء وجه الله لا اقتناء الفضيلة الانسانية ولذلك ربما اختلف المقاصد التي فيه مع ما في المسلكين الاولين فربما كان الاعتدال الخلقي فيه غير الاعتدال الذي فيهما وعلى هذا القياس ، بيان ذلك أن العبد إذا أخذ إيمانه في الاشتداد والازدياد انجذبت نفسه إلى التفكير في ناحية (374)
ربه ، واستحضار أسمائه الحسنى ، وصفاتة الجميلة المنزهة عن النقص والشين ولا تزال
تزيد نفسه انجذابا ، وتترقى مراقبة حتى صار يعبد الله كأنه يراه وأن ربه يراه ،
ويتجلي له في مجالي الجذبة والمراقبة والحب فيأخذ الحب في الاشتداد لان الانسان
مفطور على حب الجميل ، وقد قال تعالى : « والذين آمنوا أشد حبا لله » البقرة ـ 165 ،
وصار يتبع الرسول في جميع حركاته وسكناته لان حب الشئ يوجب حب آثاره ، والرسول من
آثاره وآياته كما أن العالم أيضا آثاره وآياته تعالى ، ولا يزال يشتد هذا الحب ثم
يشتد حتى ينقطع إليه من كل شئ ، ولا يحب إلا ربه ، ولا يخضع قلبه إلا لوجهه فان هذا
العبد لا يعثر بشئ ، ولا يقف على شئ وعنده شئ من الجمال والحسن إلا وجد أن ما عنده
انموذج يحكي ما عنده من كمال لا ينفد وجمال لا يتناهى وحسن لا يحد ، فله الحسن
والجمال والكمال والبهاء ، وكل ما كان لغيره فهو له ، لان كل ما سواه آية له ليس له
إلا ذلك ، والآية لا نفسية لها ، وإنما هي حكاية تحكي صاحبها ، وهذا العبد قد استولى
سلطان الحب على قلبه ، ولا يزال يستولي ، ولا ينظر إلى شئ إلا لانه آية من آيات ربه ،
وبالجملة فينقطع حبه عن كل شئ إلى ربه ، فلا يحب شيئا إلا لله سبحانه وفي الله
سبحانه.
وحينئذ يتبدل نحو إدراكه وعمله فلا يرى شيئا إلا ويرى الله سبحانه قبله ومعه ، وتسقط الاشياء عنده من حيز الاستقلال فما عنده من صور العلم والادراك غير ما عند الناس لانهم إنما ينظرون إلى كل شئ من وراء حجاب الاستقلال بخلافه ، هذا من جهة العلم ، وكذلك الامر من جهة العمل فانه إذا كان لا يحب إلا لله فلا يريد شيئا إلا لله وابتغاء وجهه الكريم ، ولا يطلب ولا يقصد ولا يرجو ولا يخاف ، ولا يختار ، ولا يترك ، ولا ييأس ولا يستوحش ، ولا يرضى ، ولا يسخط إلا لله وفي الله فيختلف أغراضه مع ما للناس من الاغراض وتتبدل غاية أفعاله فانه قد كان إلى هذا الحين يختار الفعل ويقصد الكمال لانه فضيلة انسانية ، ويحذر الفعل أو الخلق لانه رذيلة إنسانيه. وأما الآن وأما الآن يريد وجه ربه ، ولا هم له في فضيلة ولا رذيلة ، ولا شغل له بثناء جميل ، وذكر محمود ، ولا التفات له إلى دنيا أو آخرة أو جنة أو نار ، وإنما همه ربه ، وزاده ذل عبوديته ، ودليله حبه.
(375)
بقي هنا شئ وهو أن هيهنا نظرية اخرى في الاخلاق تغاير ما تقدم ، وربما عد مسلكا آخر ، وهي أن الاخلاق تختلف اصولا وفروعا باختلاف الاجتماعات المدنية لاختلاف الحسن والقبح من غير أن يرجع إلى أصل ثابت قائم على ساق ، وقد ادعى أنها نتيجة النظرية المعروفة بنظرية التحول والتكامل في المادة. قالوا : إن الاجتماع الانساني مولود جميع الاحتياجات الوجودية التي يريد الانسان أن يرفعها بالاجتماع ، ويتوسل بذلك ، إلى بقاء وجود الاجتماع الذي يراه بقاء وجود شخصه ، وحيث أن الطبيعة محكومة لقانون التحول والتكامل كان الاجتماع أيضا متغيرا في نفسه ، ومتوجها في كل حين إلى ما هو أكمل وأرقى ، والحسن والقبح ـ وهما موافقة العمل لغاية الاجتماع أعني الكمال وعدم موافقته له ـ لا معنى لبقائهما على حال واحد ، وجمودهما على نهج فارد ، فلا حسن مطلقا ، ولا قبح مطلقا ، بل هما دائما نسبيان مختلفان باختلاف الاجتماعات بحسب الامكنة والازمنة ، وإذا كان الحسن والقبح نسبيين متحولين وجب التغير في الاخلاق ، والتبدل في الفضائل والرذائل ، ومن هنا يستنتج أن الاخلاق تابعة للمرام القومي الذي هو وسيله إلى نيل الكمال المدني والغاية الاجتماعية ، لتبعية الحسن والقبح لذلك ، فما كان به التقدم والوصول إلى الغاية والغرض كان هو الفضيلة وفيه الحسن ، وما كان يدعو إلى الوقوف والارتجاع كان هو الرذيلة ، وعلى هذا فربما كان الكذب و الافتراء والفحشاء والشقاوة والقساوة والسرقة و الوقاحة حسنة وفضيلة إذا وقعت في طريق المرام الاجتماعي ، والصدق والعفة والرحمة رذيلة قبيحة إذا أوجب الحرمان عن المطلوب ، هذه خلاصة هذه النظرية العجيبة التي ذهبت إليها الاشتراكيون من الماديين ، والنظرية غير حديثة ، على ما زعموا ، |
||||||
|